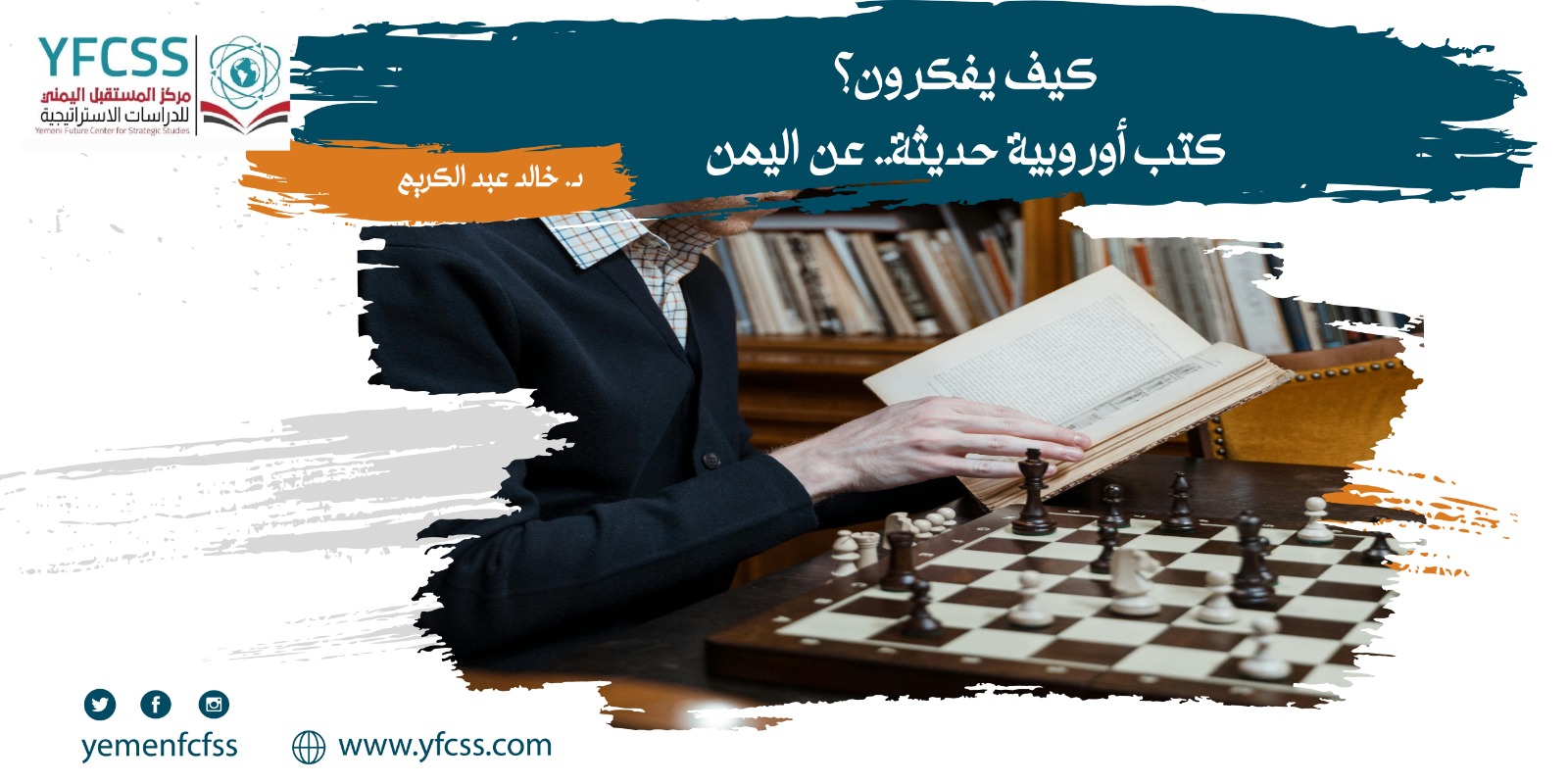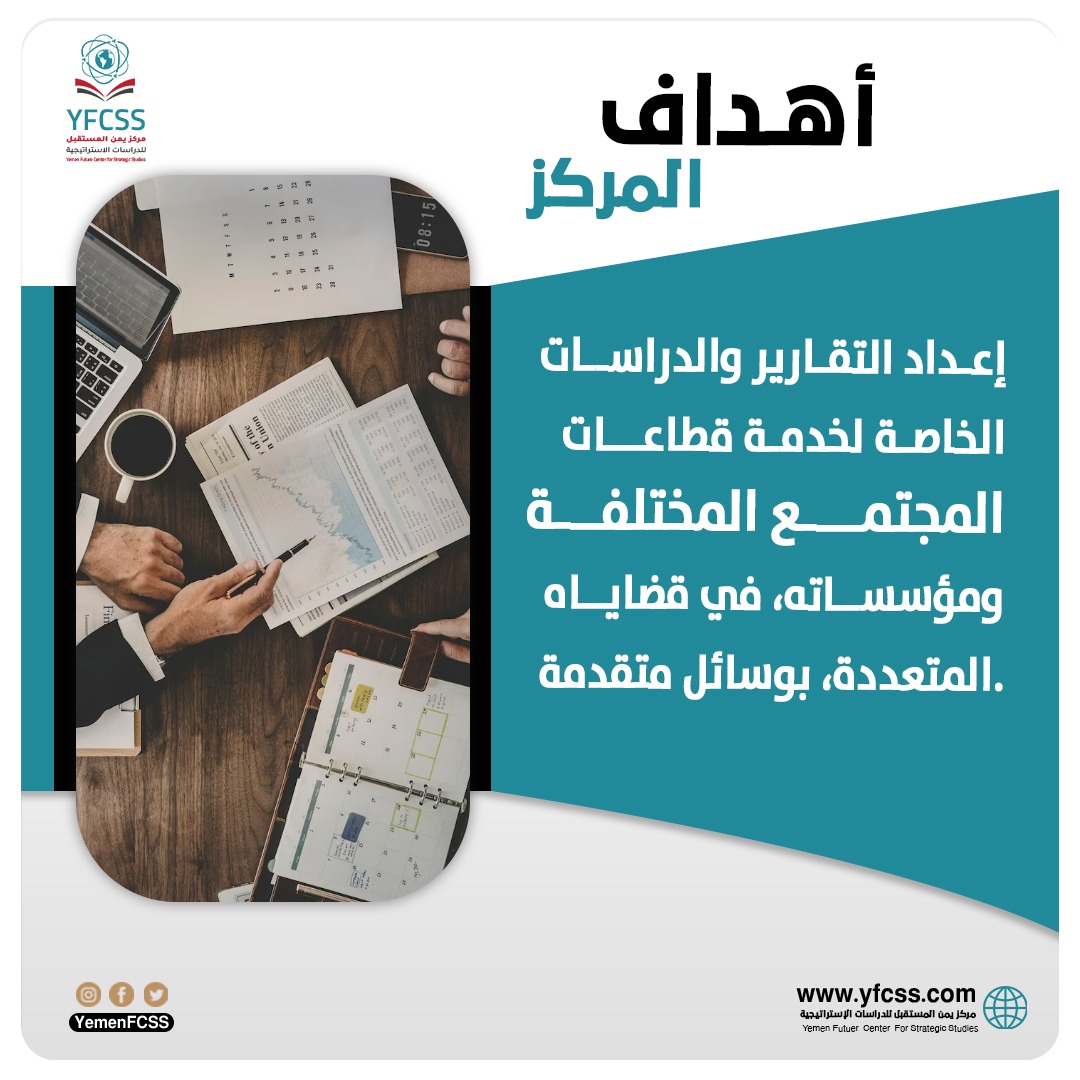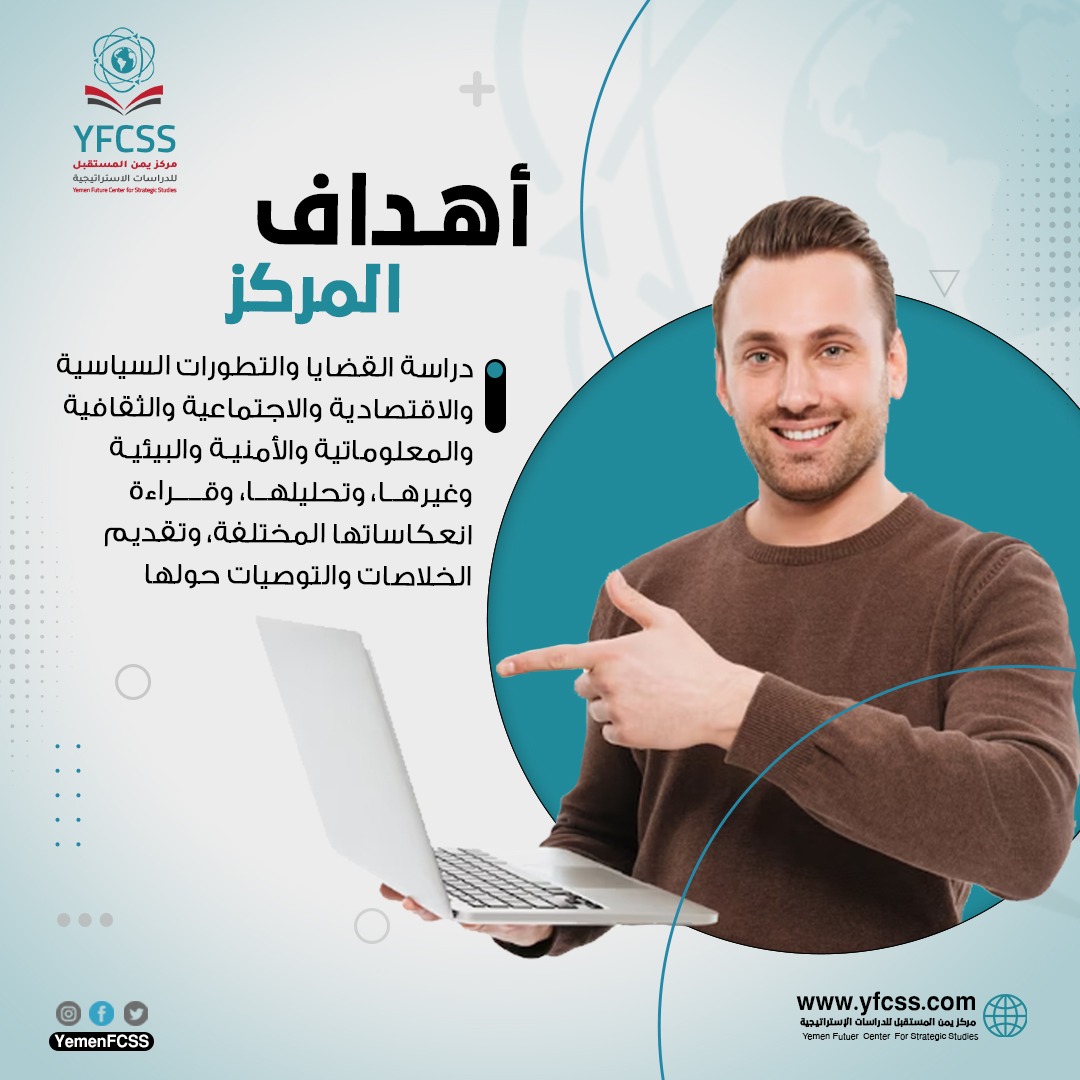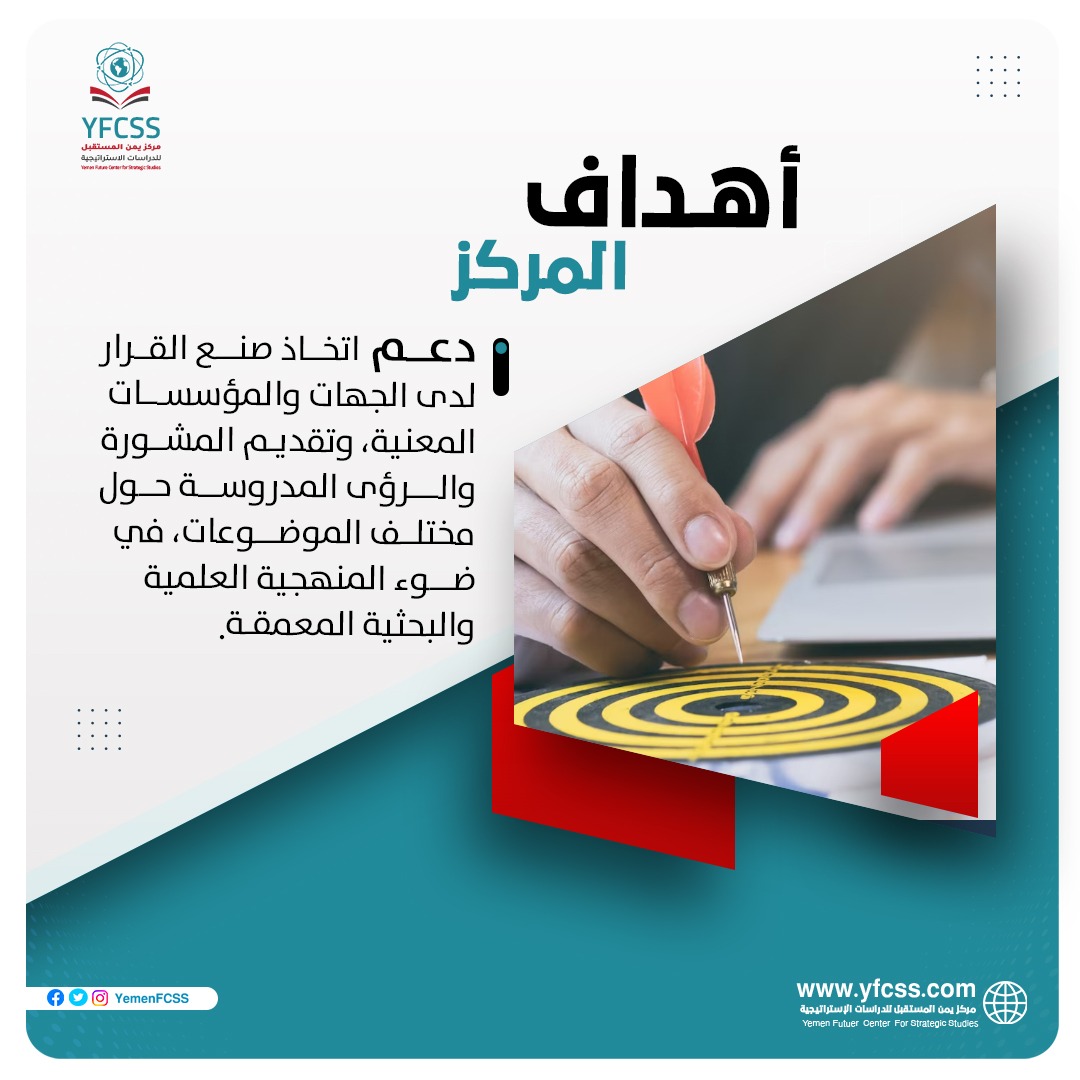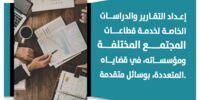كيف يفكرون؟
كُتب أوروبية حديثة.. عن اليمن
* د. خالد عبد الكريم علي
رئيس المركز الدولي للإعلام والتنمية - فرنسا
عُرفت كتابات الأوروبيين حول الصراع والحرب في اليمن باتباع سياسة متوازنة، دون الخوض في المسائل الطائفية أو التشعبات المناطقية.
كتب كثيرون عن الحرب والصراع في اليمن دون أن تُعرف عن أيٍّ منهم خلفيات عنصرية أو مواقف مناهضة لليمن واليمنيين، أو محاباة لطرف دون الآخر.
واقع الحال أن الفارق الأكبر بين من يكتبون عن اليمن ومن يكتبون عن دول المغرب العربي وبلدان شرق آسيا، هو أن الكتابة عن هذه الأخيرة لا تزال تتحرك وفق المنطق الكولونيالي القديم، بينما تحكم الكتابة عن اليمن رؤية مستقبلية تغيب فيها العداوة والذاكرة الاستعمارية لصالح أفق إنساني أكثر انسجامًا.
كتاب عن المعارضة السياسية في الجمهورية الثالثة
أحدث كتاب سياسي عن اليمن كان للأكاديمي والدبلوماسي الألماني جينز هايباخ، حيث تتبع فيه نشأة ونشاط تكتل أحزاب اللقاء المشترك في اليمن. صدرت الطبعة الأولى من الكتاب أواخر عام 2024 باللغة الإنجليزية عن دار نشر جامعة سيراكيوز.
عمل هايباخ في صنعاء ضمن البعثة الدبلوماسية الألمانية خلال عامي 2008-2009، حيث شغل منصبًا في الملحقية السياسية، وتابع الأحداث في اليمن، وكتب عنها رسالة الدكتوراه التي ناقشها عام 2017 في مركز دراسات الشرق الأوسط بألمانيا، بعنوان “منطق التعاون في الأنظمة الأوتوقراطية”. ويقصد بها الأوتوقراطية الليبرالية التي تحترم الحقوق والحريات في ظل حكّام تمكنوا من بسط نفوذهم عبر الحضور الكاريزمي وفهم تعقيدات المجتمع، مع إشراك السياسيين والمثقفين والعسكريين، إضافة إلى الزعامات القبلية والدينية في شؤون الحكم.
صدر الكتاب لاحقًا تحت نفس العنوان مع إضافة فرعية: “المعارضة السياسية في الجمهورية اليمنية الثالثة”. يبدو أن الكاتب اعتمد النموذج الفرنسي في منح أرقام للمنعطفات التاريخية التي مرت بها الأنظمة الجمهورية، واعتبر الدولة اليمنية الموحدة عام 1990 بداية للجمهورية اليمنية الثالثة.
تناول الكتاب نشأة ونشاط أحزاب المعارضة التي تأسست عام 2003 تحت مسمى تكتل أحزاب اللقاء المشترك، مشيرًا إلى خوض التكتل الانتخابات الرئاسية عام 2006، حين دعمت أحزابه مرشحها فيصل بن شملان ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح. ورغم خسارة بن شملان، إلا أن حصوله على 22% من أصوات الناخبين كان مؤشرًا على توسع شعبية التكتل، الذي بدأ بفرض شروطه على الساحة السياسية اليمنية.
تألفت أحزاب التكتل من:
التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، حزب البعث العربي الاشتراكي (السوري)، حزب الحق (الحوثيين)،حزب القوى الشعبية.
ارتفع سقف مطالب التكتل ولم تعد تقتصر على تقاسم السلطة، بل تجاوزت ذلك إلى المطالبة بتغيير النظام. لذلك، في خضم أحداث الربيع العربي في فبراير 2011، دعت أحزاب اللقاء المشترك كافة المكونات الحزبية والمجتمعية إلى النزول إلى الشارع ومساندة المحتجين المطالبين بإسقاط النظام. كان الشباب المتظاهرون يدعون أحزاب اللقاء المشترك إلى تبني مطالبهم بعيدًا عن دعوات الحوار التي قدمها الرئيس اليمني آنذاك علي عبد الله صالح.
يرى الكاتب هايباخ أن سنوات الحرب غيرت مجرى التاريخ اليمني المعاصر. إلا أن ذلك لا يعني أن أحزاب اللقاء المشترك اختفت من الساحة السياسية، لكنها، وبحسب الكاتب، مثل كل شيء آخر في اليمن، فقد أُعيد تشكيلها وفق الانقسامات الحالية، وعلى أساس التباينات السياسية التي طرأت عليها، مما أدى إلى تكيفها مع حقائق سياسية جديدة. باستثناء بقايا أحزاب المشترك المتمركزة في صنعاء، والتي أصبحت طوعًا بيد الحوثيين، إذ لا تملك من تاريخها شيئًا سوى الذكريات المليئة بالحنين لقادتها المقيمين خارج اليمن.
كتاب جينز هايباخ هو الأول الذي يتناول تجربة أول تكتل حقيقي للمعارضة في اليمن. في الواقع، هو حصيلة ثلاثة عقود من الدراسات حول الهياكل السياسية في اليمن، بدأها بتحليل حرب صيف 1994، مفندًا الأهداف والسياسات التي انتهجتها الأحزاب اليمنية خلال تلك الفترة وما بعدها.
استفاد الكاتب من أبحاث أكاديميين متخصصين في الشأن اليمني، منهم:
- ستايسي فيلبريك ياداف، أستاذة العلاقات الدولية في كلية هوبارت ويليام سميث في جنيف ونيويورك.
- ليزا ويدين، أستاذة العلوم السياسية ومديرة مركز شيكاغو لدراسة القضايا المعاصرة في جامعة شيكاغو.
أضافت هذه الأبحاث قيمة كبيرة إلى الأدبيات التي استند إليها الكاتب، خاصة في أربعة جوانب رئيسية:
أولًا: ملء الفراغ البحثي المتعلق بالفترة الممتدة بين صعود وسقوط تكتل أحزاب اللقاء المشترك.
ثانيًا: تقديم وجهة نظر محايدة على دراية عميقة بالعوامل التي أدت إلى تعثر التعددية السياسية الديمقراطية في اليمن، مع كشف دور اللقاء المشترك في تثبيت النظام عام 1994 ثم التسبب في انهياره لاحقًا.
ثالثًا: تقديم لمحة عن الشخصيات الكاريزمية التي رسمت ملامح السياسة اليمنية، مما يزيد من أهمية تلك الصفحات، خاصة في ظل وفاة بعض تلك القيادات، وتقدم الآخرين في السن، وصعوبة الوصول إلى من تبقى منهم.
رابعًا: استعراض برامج الأحزاب المكونة للتكتل والعوامل التي أدت إلى انهياره، وبالتالي انهيار النظام السياسي الأوسع في اليمن.
بشكل عام، يأتي الكتاب منصفًا للنظام السابق، ويخاطب القراء من الجيل الجديد الذين يفتقرون إلى معلومات دقيقة عن خلفيات الصراع، حيث يتم الترويج لسرديات مغلوطة عن النظام السابق، إن لم يكن قد جرى الإخفاء المتعمد لحقائق حول التعددية السياسية التشاركية.
لكن يُؤخذ على الكاتب إغفاله الإشارة إلى أن تكتل اللقاء المشترك أصبح شريكًا ائتلافيًا مع المؤتمر الشعبي العام خلال الفترة الانتقالية (2012-2014)، وتأثير تلك الشراكة على تعجيل انهيار مؤسسات الدولة والتهيئة للحرب والصراع المستمر.
إلى جانب أهميته التوثيقية، يبحث الكتاب التجربة الديمقراطية في اليمن من زاوية التعددية الحزبية، وهو موضوع لم يُتناول بالتفصيل من قبل.
من وجهة نظري لا تزال التحالفات الكبرى تحتل موقعًا في الخارطة السياسية لليمن، حيث أُعلن في 5 نوفمبر 2024 عن تشكيل التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية المتحالف مع مجلس القيادة الرئاسي، والذي يمكن اعتباره نسخة معدلة من اللقاء المشترك، لكن هذه المرة بإشراك المؤتمر الشعبي العام.
لكن هل تعني العودة إلى التعددية الالتزام الحقيقي بقيمها؟ وهل يمكن للنخبة السياسية المقيمة في الخارج أن تلامس معاناة الداخل؟
يُعد الكتاب عصي الفهم على القارئ الأوروبي، لكنه مرجع قيّم للأكاديميين والباحثين في مجال العلوم السياسية والمختصين بالشرق الأوسط والتاريخ السياسي اليمني.
القبائل في اليمن الحديث – مختارات
كتاب القبائل في اليمن الحديث – مختارات (بالإنجليزية)، الصادر عام 2021، للكاتبة النمساوية مارييك براندت، وهي باحثة أولى في معهد الأنثروبولوجيا الاجتماعية (علم الإنسان) في الأكاديمية النمساوية للعلوم. تُعَدُّ من القلة المهتمين بدراسة الأصول والأنساب والعرف الذي ينظم الحياة الاجتماعية للقبائل اليمنية. درست اللغة العربية في صنعاء وأقامت فيها خمس سنوات (2006-2011). وقد تعمقت أبحاثها العلمية في الخطاب الفكري والأيديولوجي الحديث لقبائل اليمن، وهو مجال غير مستكشف، ما جعلها تحظى بالعديد من الزمالات المرموقة، كما حظيت بحوثها باعتراف دولي واسع. تُدعى براندت لإلقاء محاضرات في جامعات مرموقة مثل أكسفورد، وهارفارد، وبرينستون، حول موضوع القبيلة والأنساب والأعراق.
الكتاب عمل مشترك، يضم مجموعة أبحاث قُدِّمت في ندوة علمية عُقدت في العاصمة النمساوية فيينا عام 2018، هدفت إلى إعادة التفكير في الدراسات المتعلقة بالقبيلة اليمنية، وتحديث الأبحاث الخاصة بها، واستخدام المنهج العلمي لدراسة تاريخ العرف القبلي في اليمن، إلى جانب تقديم رؤى جديدة لمناقشة القبلية باعتبارها ظاهرة تاريخية متأصلة في ثقافة وفكر وجذور الإنسان اليمني. وقد حققت الندوة نجاحًا كبيرًا، يُعزى إلى كفاءة المشاركين ونوعية الأبحاث المقدمة. وقد شارك فيها باحثون من جنسيات مختلفة، منهم ستيف كاتون ودانييل فاريسكو من الولايات المتحدة، وبول دريس وهيلين لاكنر من بريطانيا، وميخائيل روديونوف من روسيا، إضافة إلى مارييك براندت من النمسا.
استهلَّت الدكتورة براندت الكتاب بمحاولة إيضاح مفهوم القبيلة، حيث كتبت:
“في اليمن، تُعد القبيلة مفهومًا تاريخيًا متجذرًا للتمثيل الاجتماعي، على الرغم من أن تعدد أشكال هذا المصطلح وغموضه يجعل صياغة تعريف عالمي قابل للتطبيق أمرًا شبه مستحيل. على مدى القرون الماضية، خضع مفهوم القبيلة في اليمن – الذي تعود جذوره إلى العصور القديمة – للعديد من التغيرات، لكنه ظل يتميز بعوامل الديمومة والاستمرارية. واليوم، مع التغيرات السياسية الكبرى، واندلاع الانتفاضات الشعبية، وتصاعد الصراعات الداخلية، والتدخلات العسكرية الخارجية، وضعف الدولة الناجم عن ذلك، يبدو أن القبلية تكتسب أهمية متزايدة، وتملأ جزئيًا الفراغ الذي خلفه تراجع دور الدولة. وهذه هي الأشكال الحديثة للقبيلة في اليمن التي يسعى هذا الكتاب إلى استكشافها”.
أما فيما يتعلق بأفول دور القبيلة خلال فترات معينة، فقد ورد في الصفحة 13 من الكتاب:
“خلال القرن العشرين، وفي العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كانت العلاقة بين الدولة والقبائل متأرجحة بين الغموض والتناقض، حيث سعت الحكومات إلى إعادة تشكيل المجتمعات القبلية. وينطبق هذا أيضًا على العديد من مناطق جنوب وشرق اليمن، حيث كانت قبائلها، رغم جذورها التاريخية، هدفًا لسياسات الحد من النزعة القبلية، أولًا في سياق سياسة المحميات البريطانية، ثم في ظل أيديولوجية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية”.
تُشير مارييك براندت إلى أن ظاهرة الثأر قد تتخذ أشكالًا سلبية، حيث يصبح الانتقام غير مقيد بالقواعد والأعراف القبلية عند ضعف السلطة، مما يؤدي إلى انتهاك الأعراف التقليدية، مثل استهداف النساء والأطفال. كما تؤكد الكاتبة على حساسية قضايا الدم والثأر في فهم جزء من الآليات الاجتماعية والسياسية للصراع الحالي في اليمن.
أما أبحاث الأكاديميين الآخرين الواردة في الكتاب، فقد تناولت موضوعات مختلفة وفقًا لاختصاص كل باحث وخبرته. من بينهم من كتب عن استخدام القبيلة لقوتها في بناء الإجماع وحل النزاعات، ومنهم من أجرى مقارنات بين حرب ستينيات القرن الماضي والصراع الحالي، مشيرًا إلى أن الحل قد يكمن في الآليات نفسها التي أوقفت تلك الحرب، رغم تعقيدات الوضع الراهن.
كما يتطرق الكتاب إلى مسألة عودة الأحكام القبلية عند ضعف الدولة، إذ يشير إلى أنه منذ عام 2011، ومع تصاعد الاضطرابات، أصبح العرف القبلي الوسيلة الأساسية لتنظيم الزراعة وتقاسم الأراضي والمياه في المرتفعات الشمالية لليمن، ما يدل على أن القبيلة يمكن أن تلعب دورًا في استدامة النظام الزراعي والسلام الاجتماعي، سواء بوجود الدولة أو في غيابها.
البحث الوحيد في الكتاب الذي تناول البنية الاجتماعية خارج المرتفعات الشمالية، قدَّمه عالم الأنثروبولوجيا ميخائيل روديونوف، أستاذ الدراسات الشرقية بجامعة سانت بطرسبرغ الحكومية وعضو الأكاديمية الروسية للعلوم. حمل بحثه عنوان: “إعادة التقسيم الطبقي الاجتماعي في حضرموت خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية: نظرة أنثروبولوجية”. يعرّف فيه الطبقية الاجتماعية في حضرموت باعتبارها تسلسلًا هرميًا ثابتًا قائمًا على الولاء للمكانة الموروثة، حيث تتمثل أسس هذا النظام في:
1- مبدأ التوافق الزوجي مع الميل إلى تعدد الزوجات.
2- نظام الأنساب المُعلن.
3- التوزيع المحدد للوظائف الاجتماعية والاقتصادية.
اليوم، وفقًا لروديونوف، يسعى الأفراد الأكثر طموحًا في الطبقات الدنيا بحضرموت إلى تعزيز مكانتهم، إما من خلال الانتساب إلى سياقات قبلية، أو عبر الانضمام إلى التجمعات الإسلامية المتطرفة التي توفر لهم مكانة اجتماعية مكتسبة.
يكتب روديونوف في الصفحة 139:
“لقد حاول النظام الماركسي في جنوب اليمن، من خلال مفهومه للطبقات الاجتماعية، ليس فقط تغيير النظام الطبقي، بل تقويضه بالكامل عبر إلغاء معظم وظائفه الاجتماعية والاقتصادية، وحتى تغيير أسماء الطبقات. فقد استُبدلت تسميات مثل (العبيد) و(الضعفاء) بمصطلح (العمال). كما تم نزع سلاح القبائل، وطُرد زعماؤها (المقادمة) والقضاة القبليون”.
وفيما يتعلق بالتوجهات السياسية لقبائل حضرموت، كتب روديونوف:
“يبدو أن حضرموت كيان متماسك يسعى إلى تحقيق رؤيته السياسية، إما بالحصول على حكم ذاتي ضمن الدولة الجنوبية، أو حتى بالاستقلال التام” (صفحة 140).
أما الباحثة البريطانية هيلين لاكنر، فاستنادًا إلى خبرتها الطويلة ومعرفتها العميقة باليمن، فقد رفضت التبسيط المفرط لمفهوم القبيلة، مؤكدة أن التركيز على الهوية القبلية وحدها يعني تجاهل الانتماءات المهنية والسياسية الأخرى. كما تناولت العوامل الاقتصادية والتنموية باعتبارها محركات رئيسية للتغيير الاجتماعي والسياسي في اليمن.
يخلص الكتاب، من خلال مراجعة مفاهيم الأصل، والتنظيم، والتعاون، والقانون العرفي، والشرف، وأخلاقيات العمل، والمساواة الأخلاقية، ومكانة المرأة، إلى أن مفهوم القبيلة يشمل فهمًا متعدد الأبعاد للقبيلة كنظام أخلاقي واجتماعي وسياسي وقانوني. وعلى الرغم من أهمية النسب والأنساب، فإن السلوك والتعاملات تحظى بمكانة أكبر في تحديد الهوية القبلية.
في ظل الواقع المضطرب في اليمن، أثبتت القبيلة أنها كيان مرن قادر على التكيف مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وعلى الرغم من نجاح الكتاب في تقديم رؤية تحليلية ضمن إطاره النظري والجغرافي، فإن الحاجة لا تزال قائمة لإجراء مزيد من الدراسات حول وضع القبيلة في اليمن ككل، وليس فقط في المرتفعات الشمالية.
إن توسيع النطاق الجغرافي للدراسات القبلية سيُسهم في تصحيح الكثير من التفسيرات الخاطئة لمصطلحي القبيلة والقبلية، لا سيما في اليمن الأوسط والجنوب، فضلًا عن تحليل الهياكل الاجتماعية للمراكز الحضرية الكبرى مثل عدن وصنعاء.
نمط الحياة في قرى المرتفعات
تتسم كتابات البريطانيين عن اليمن بالتنوع بين التوثيق وأدب الرحلات والمذكرات. في كتابها خبز وحِنَّاء، الصادر بنسخته الإنجليزية في لندن عام 2023، تستعيد الكاتبة البريطانية لانثي ماري ماكلاجان ذكريات تجربة عاشتها في اليمن قبل أربعة عقود. تصف ماكلاجان حياة النساء في بلدة صغيرة تقع في أعالي الجبال الغربية لليمن في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، حيث عاشت هناك عامًا ونصف العام أثناء إجرائها دراسة تطبيقية عن الوضع الاجتماعي في قرى المرتفعات اليمنية، وذلك لنيل درجة الدكتوراه من جامعة لندن.
تحسب لماكلاجان الريادة في توثيق مرحلة وُصفت بأنها مزدهرة بشكل خاص للمواطنين في الجمهورية العربية اليمنية آنذاك، بسبب بدء اليمن بتصدير النفط. وهناك سبب آخر لا يقل أهمية، وهو أموال المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية، حيث كانوا قادرين على السفر والعمل دون تأشيرة أو قيود إدارية. وقد كان لذلك تأثير كبير على الحياة اليومية في المرتفعات الريفية، مما أدى إلى تغيير نمط حياة الأسر بشكل ملحوظ.
ورغم أن الكتاب لا يناقش هذه المسألة بشكل مباشر، إلا أنه يقدم صورة واقعية ومفصلة للغاية عن الرفاهية التي سادت حياة الريف آنذاك، ويصف التغيرات التي طرأت على قرى المرتفعات نتيجة التأثر بالجوار وتحسن المستوى المعيشي للأفراد والمجتمع. كما تتناول الكاتبة في كتابها الأزياء، والطقوس المتعلقة بالمواليد والزواج والمناسبات والأعياد، إلى جانب الأسواق والمهن والحرف التقليدية.
احتوى الكتاب على مجموعة من الصور التي التقطتها ماكلاجان، والتي تُظهر سحر المكان وعبقه.
حُلو ومُر: المأكولات في اليمن
قد تندهش إذا علمت أن الكتاب الأكثر مبيعًا بين الكتب الصادرة عن اليمن، والذي طُبعت منه نسخ بالفرنسية والتركية بالإضافة إلى نسخته الإنجليزية، هو كتاب عن الأطباق اليمنية وعلاقتها بالمناطق المختلفة، بعنوان حُلو ومُر: المأكولات في اليمن، الصادر بالإنجليزية عام 2024. غلبت الصور على النص الذي كتبته سيدتان هما مارتا هولبورن وجيسيكا أولني.
نظرًا لظروف الحرب ولأسباب أمنية حالت دون تنقلهما بين المناطق اليمنية، وجدتا ضالتهما في مخيم للنزوح في مأرب، حيث التقتا نازحين من محافظات يصعب الوصول إليها. ومن ثم، زارتا حضرموت (الوادي والساحل) وسقطرى وتعز وعدن، وبذلك اكتمل زادهما المعلوماتي لإنجاز الكتاب.
بعض الصور كانت تغني عن النص، مثل صور المطابخ والطهي، وحبوب البن والذرة، وإنتاج العسل.
خُصصت الصفحات الأولى للتعريف بتاريخ وحضارة اليمن، جغرافيته، موارده الطبيعية، والحياة البرية والنباتية، ثم ينتقل الكتاب إلى موضوعه الرئيسي.
جزء من عائدات مبيعات الكتاب سيتم التبرع به لبرنامج الغذاء العالمي.
في كل الأحوال، أسهم الأوروبيون الذين كتبوا عن اليمن في تزويد القارئ والمهتم والأكاديمي الأوروبي بالكثير من الحقائق والتفاصيل عن طبيعة اليمن وصراعاته، وعن تأثير السنوات العشر الأخيرة على أرضه وشعبه وإرثه الحضاري. علمًا أن نسخًا من تلك الإصدارات تُودع في الجامعات الأوروبية، ومراكز الأبحاث، ومؤسسات صناعة القرار.
من المؤسف أن يحدث هذا في ظل غياب أي نشاط رسمي يمني يعمل على استثمار المصالح المشتركة والتواصل مع الرأي العام الأوروبي. كما لا توجد أية مخاطبة دؤوبة ومتواصلة مع القارئ والمتلقي الأوروبي من قِبل من يُفترض أنهم مؤثرون يمنيون. لم يسبق أن رصدنا نشاطًا في هذا الاتجاه.
قد يقول قائل: لا جدوى، فالغربيون لا يتأثرون بأحداث اليمن. وربما لا تخلو هذه الحجة من الصحة، إذ تتفاوت درجة التأثر بما يحدث في اليمن بين دولة أوروبية وأخرى. وهذا في حد ذاته سبب يدعونا لبذل جهد أكبر في إنتاج إصدارات أكثر بلغات متعددة، واستمالة المثقفين والصحفيين والكتاب الأوروبيين الذين نُجزم بقدرتهم على التأثير.